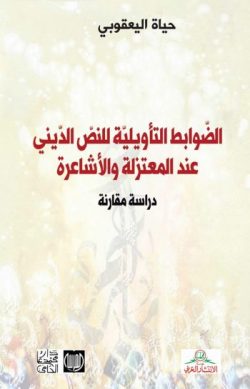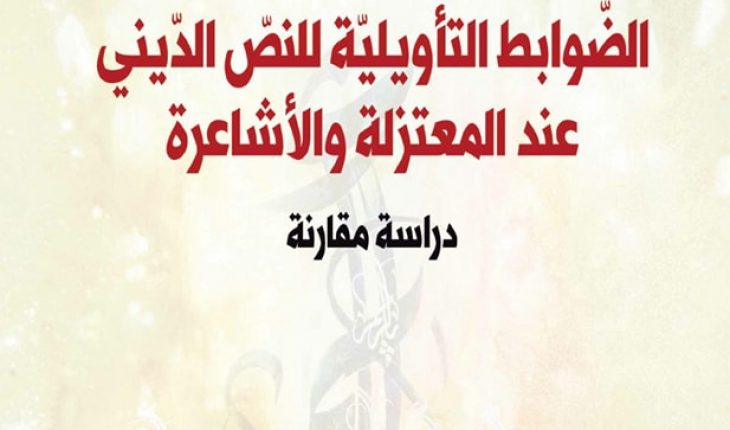صدر منذ أيام قليلة عن دار محمد علي الحامي والانتشار العربي كتاب لافت للانتباه. عنوانه الضوابط التأويلية للنص الديني عند المعتزلة والأشاعرة،دراسة مقارنة. وهو لافت لا فقط لموضوعه بل كذلك لأنه بقلم نسائي. لقد كتبت حياة يعقوبي هذا الكتاب في أحضان جامعة الزيتونة العريقة لكنها كمَثل كثير من رجال الزيتونة ونسائها نسجت على منوال التحديث النابع من أعماق مؤسسة ارتبطت في الذاكرة الجماعية بالمحافظة وحراسة التراث فشقّت طريقا من الداخل إلى رحاب الحداثة. والطريف أن هذا الكتاب الذي كان في الأصل أطروحة دكتورا نوقشت في جامعة الزيتونة أشرف عليه فيلسوف من خارج أسوار المعرفة التقليدية هو الأستاذ محمد محجوب، وهكذا فإن قارئ هذا النصّ سيرى تقاطع المعرفة الدينية الأصيلة بتلك الروافد الفكرية الحداثية تنسجها أنامل أنثى تجابه لا أطنانا من التقاليد المتكلسة بل كذلك عوائق كامنة في قلب التراث الكلامي الأشعري والمعتزلي على السواء. وهذه المعارف الكلامية تبحث في الجوهر عما يقصده الله أو مايريد قوله في قرآنه للبشر
ففي هذا الكتاب نرتحل في عقل المتكلمين ونجول في أدق دقائق فهمهم للغة وللوجود وهو فهم سينعكس في تأويلهم للقرآن واستخراج معانيه. وفي هذا الكتاب سنكتشف الفرق بين عقائدهم وآليات تفسيرهم وأصول ذلك الفرق ومآلاته. ومن أهم مظاهر التأويل أن يفترقوا في مسائل تتعلق بجوهر منزلة الإنسان كمسالة الإرادة والفعل وخلق الأفعال وخلق القرآن والمسؤولية والجزاء. وقد كشفت اليعقوبي كيف تقوم الحقائق على المواضعة والاستعمال وكيف يتعامل المتكلمون مع المجاز وكيف يتصرفون في السياق والقول ليعبروا عن خلفياتهم الكلامية وتصوراتهم العقائدية. وهؤلاء يحاولون ربط الصلة بين عالم الدنيا وعالم الغيب فيعبرون عبر المجاز إليه. وإذا بهم يتصورون صفات الخلق والخالق وشروط الألوهية على نحو ما كانت تلك العقائد
إن القارئ الشغوف بمعرفة دقائق تراث الإسلام سيجد متعة فكرية في مطالعة هذا الكتاب الذي جمع له بمهنية الباحث الجامعي نصوصا أساسية من التراث الكلامي الأشعري والمعتزلي فعرض ولخص وحلل أهم فواصل عقائدهم من خلال تلك النصوص، فتجد الأشعري والبصري وابن تيمية والجاحظ والقاضي عبد الجبار والجرجاني والرازي وابن رشد والزمخشري والزركشي والغزالي وابن عاشور والماوردي وابن قتيبة والفارابي وابن قيم الجوزية وابن حزم والشهرستاني وغير هؤلاء. تجدهم في متن نص حياة يعقوبي يتحاورون ويتخاصمون والكاتبة تحلل حوارهم وخصامهم بعيون دريدا وفوكو وبارط وتقارن بينهم وتشرح مرجعياته العقائدية والمنهجية وتعيّن أصل ذلك الخصام المتمثل في تمثلاتهم اللغوية ومنزلة الوجود
ولعلّ مثل هذا الكتاب يكشف للناس أولا أن النساء لسن ناقصات عقل ودين فها هن يكتبن في العقل وفي الدين ويشرحنه ويشرحن أصوله الفلسفية الكلامية العميقة. وثانيا يكشف مثل هذا الكتاب أن الإسلام ليس فقط ضرب الرقاب وطعن الصدور وتفجيرات ولا هو فقط عبادات وصلاة وصيام وقيام. بل الإسلام فكر وعلم وتفلسف وأصول كلام وفن ومعارف دقيقة وتاريخ من الفكر والاختلاف والاجتهاد والتعقل في الوجود. وثالثا مزية الكتاب أنه يصل القراء بتراثهم وبجزء من تراثهم غاب عنهم بفعل الايديولوجية المالكية في تونس مثلا أو بفعل هزيمة المعتزلة التاريخية أو بفعل الزمن والتقادم فها هي حياة يعقوبي تعيد حثنا على التواصل مع جزء من الذاكرة هو تلك الثقافة الحية القائمة على السجال والجدال في أمور العقيدة والفكر والدين بلا خوف ولا رعب من أن يقال عن المتكلم أنه كافر أثيم. ولذك صدقت حين قالت أن آباءنا كانوا أكثر جرأة منا في الخوض في غمار التفكر في الدين. وكذلك صدقت حين دعت قراءها إلى نفض الغبار عن التراث الخفي الذي يحمل فكرا وعقلا وشجاعة ولكن الأحداث التاريخية غيبت تلك الكفة ورجحت كفة الجمود والتكلس والاجترار
هذا كتاب يقرؤه المختصّ فيجد فيه حديثا عن الانسجام في النص المقدس والتأويل عند المتكلمين والخلافات المذهبية بينهم والاعتزال والأشاعرة والضوابط التي وضعوها لفهم القرآن ويقرؤه غير المختص فيتعرف إلى خلافات كانت ولا تزال مؤثرة في حياة المسلمين من جهة وإلى إسلام المعتزلة القائم على العقل من جهة ثانية. وقد بينت الباحثة أن أخطر فكرة في التراث الإسلامي برمته هو ادعاء امتلاك حقيقة ما يريده الله ولكن هل الإنسان المحدود قادر فعلا على فهم مراد الله اللامحدود؟ لعل قراءة الكتاب تضيء جوانب لهذا السؤال العميق
بقلم زينب التواجاني