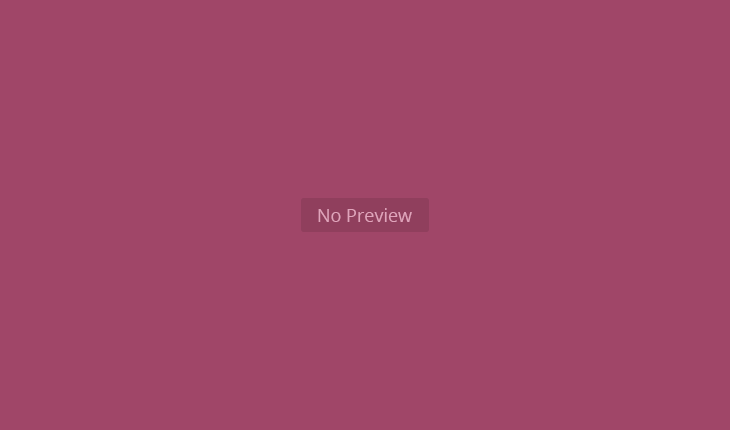وأخيرا نطق رئيس الجمهورية باسم الفخفاخ باعتباره الأنسب ليتكفّل برئاسة الحكومة في اللحظة الراهنة. وهو لم يكن في الحقيقة الشخصية الأمثل مقارنة بغيره من الذين اقترحتهم الأحزاب النافذة في البرلمان، بل بالعكس انتقاه السيد سعيد من حزب اعتبر أوّل ضحية من ضحايا التي اكتوت بنار التوافق مع النهضة في تجربة الترويكا
وأمام ما تواجهه البلاد من صعوبات اقتصادية وديون خارجية وما تعانيه من مشاكل بطالة وتوتّر سياسيّ يقف المرء متسائلا عن جدوى هذا التعيين؟ وخاصّة إذا استحضرنا ما مررنا به من مواقف حادّة إثر تعيين الجملي وحكومة الأربعين سواء تحت قبّة البرلمان أو في الشارع. وما عاشه الناس من احتباس الأنفاس نتيجة مواجهة الأحزاب للتغوّل الإخواني. وفي الحقيقة لا ننكر حالة الانفراج التي عاشها المجتمع بعد أن كُسّرت شوكة الإخوان، وعاد الأمل في مستقبل آخر يقطع مع الحاضر البائس والماضي المقيت الذي مرّت به البلاد. أضف إلى ذلك عودة الأمل في انتقال ملفّ الحكومة الجديدة إلى قصر قرطاج، وتلذّذ الناس بنعتها « بحكومة الرئيس »، رئيس هنئ بمنصبه إثر حصوله على أعلى نسبة في التصويت، فصار الرئيس المختار والقادر والنافذ بصلاحيات يفتقدها من انتخب على رأس البرلمان، وهيئت له فرصة أن ينتقي للرئاسة الثالثة والتنفيذية صفات لا حرج أن تلائم ميوله وأيديولوجيته. وباختصار نقول: سنحت للرئيس سعيد فرصة من ذهب حتى يخرج من عزلته في قرطاج وحتى يكون له تأثير في القصبة وحضور
هذا هو منطق المقاربة السياسية بعد أن تحوّل مشكل الحكومة إلى حضن الرئيس، وعلينا أن نقرأ الأحداث من هذا المنطلق، بل هناك من استرسل في هذه المقاربة لاستشراف قرارات الرئيس، من متحدّث عن شخصية غير معروفة قد تفرض فرضا، إلى قائل بأنّ هذه الشخصية ستخضع لمواصفات ستدفع إلى رفضها من المجلس أملا في حلّه وانتخابات جديدة ستفرز كتلا أقرب إلى اتجاهات الرئيس وإلى شعار « الشعب يريد »، شعار وظّفه السيد سعيد واستنزف جميع معانيه في كلّ مناسبة
ملاحظة أخرى نذكرها: وهي تنبيه الرئاسة على أنّها ستسلك منهجا في التعامل مع هذا الملفّ يخالف المتعارف عليه، وذلك سعيا إلى النجاعة، فغاب الاتصال المباشر مع الأحزاب التي ستقدّم اقتراحات، على الأقلّ في الظاهر ورسميا، وانكب الرئيس مع مستشاريه في درس الملفّات وتمحيصها. والظاهر أنّهم أقصوا شرطا هامّا ومفصليا في العملية الانتخابية، وهي التمثيلية البرلمانية لكلّ حزب ضمانا لنجاح هذا المقترح. ونحن أمام هذه المقاربة بين احتمالين، إمّا أنّ الرئيس اختار فرضية الدفع إلى انتخابات جديدة بسقوط المقترح أو لعلمه بأنّ هذه الأحزاب لن تسقط الحكومة المقترحة إنقاذا لوجودها داخل المجلس؛ وعلى هذا الأساس فإنّ الرئاسة في حلّ من قيد هيمنة الأحزاب النيابية
ومع ذلك لم يكن في الحسبان البتّة أن تختار الرئاسة شخصية هي الأضعف في الدعم البرلماني، إذ اقتُرِح السيد الفخفاخ من حزب الشاهد لا غير، بينما نافسه رجال نالوا إجماعا من كتل نيابية تضمن لهم حزاما نيابيا يسمح لهم بالعمل في راحة برلمانية. وفي هذه المسألة تطرح أسئلة كثيرة: ماهي المعايير الموضوعية التي يمكن أن تفرز الفخفاخ؟ هل هي الكفاءة؟؟ لكنّه برهن عن فشله في فترة الترويكا. هل هناك تناغم أيديولوجي بين اتجاهات سعيد وحزب التكتّل؟؟؟ أم خيوط تتحكّم في عمليّة الانتقاء؟؟ وماهي قوانين اللعبة الخفية التي تكمن وراء تعيينه دون سواه؟
للإجابة عن هذه الأسئلة علينا أن نفهم من هو الفخفاخ؟ وماذا بقي في الذاكرة الجماعية لهذا الرجل؟
هو من حزب التكتّل، حزب خان قواعده الانتخابية في 2011 عندما تكتّل مع الإخوان وكان مطيّة حتى يركبوه لإعلان وسطيتهم. شارك الفخفاخ في حكومتي الجبالي والعريض سنتي 2012 و2013؛ وترشّح للرئاسية سنة 2019 باسم حزب التكتّل
لكن، ورغم قصر المدّة في تجربته الوزارية احتفظت له الذاكرة الجماعية بإنجازات اعتبرت إلى يومنا هذا بابا فُتِح لدحرجة تونس في دهليز الإفلاس والتدهور الاقتصادي، ونكتفي بأهمّ نقطة: فقد تمّ تعيينه على وزارة المالية بعد استقالة الديماسي الذي رفض التعويضات للمنتفعين بالعفو التشريعي العام؛ الأمر الذي كان له عظيم الأثر على السياسة المالية والاقتصادية بالبلاد. وكان صاحب بدعة » الاتاوات »، ومتعلّلا بأنّ هذا الحلّ » الفقهي »، أي الذي أتى به علماء في القرون الوسطى هو الذي سيجنّب البلاد من الإفلاس. ويمكن نعت الفخفاخ بصاحب القروض، إذ في عهده بدأنا قصّة معاناتنا مع صندوق النقد الدولي لأول مرة منذ ثمانينات القرن الماضي؛ ونسب إليه مشروع اصطلح عليه برسالة « النوايا السرية »، وهي عبارة عن التزامات قدّمتها الدولة التونسية لصندوق النقد مقابل سلسلة من القروض؛ ومنذ ذلك التاريخ تحوّلت هذه الالتزامات إلى قيود كبّلت جميع الحكومات المتعاقبة إلى يومنا هذا
والسؤال، إلى أيّ مدى يمكن اعتبار الفخفاخ شخصية مستقلّة وجامعة؟ وهل يمكن الوثوق من تحفّظ النهضة تجاه تعيين الرّجل؟
في الحقيقة نحن لا نأتي بالجديد عندما نقول إنّ قصّة الفخفاخ مع النهضة عريقة، وعندما طلب من قياداتها الدعم في التزكيات الرئاسية استجابوا لندائه استجابة رجل واحد، فقد زكّاه 8 من الإخوان من جملة 10؛ وينهض هذا الموقف دليلا على أنّ الرجل على العهد. ولذلك لا نقف على نشاز في مواقف الإخوان منه، وجميع أصواتهم تؤكّد على أن لا تحفّظ من تعيينه
ثمّ لا تغرّنا الوعود التي قدّمها في الحملة الرئاسية: من موقف حداثي يقرّ بالمساواة بين الجنسين في الميراث إلى قبول المثلية. وغيرها من المبادئ التي تنادي بها القوانين الدولية. فهي تندرج في سياق حمّى المزايدات لا غير
لكن، هناك من الوعود ما يمكن أن نحمله محمل البرنامج، لأنّها تنضوي على مشمولاته باعتباره رئيس حكومة: فقد تحدّث الفخفاخ عن مشروعه الاقتصادي المتكامل والذي يشتمل على تصوّرات وطرق لتعبئة الموارد المادية عبر العلاقات الخارجية لإطلاق مخطّط استثماري يهدف إلى تحسين النموّ وإدماج تونس في الثورة الصناعية الرابعة لتكون محرّكا رئيسيا لاقتصاد البلاد
وقوام هذا المشروع 4 ركائز هي، الاستثمار في التعليم والبحث العلمي، مع تنبيهنا إلى أنّ هذا القطاع يعيش حالا من الانزلاق نحو المجهول منذ 2011، ففقدت مقوّمات الجودة، وتراكمت مشاكله وتعقّدت، وهو ملفّ يحتاج إلى تربّص ونظر. أمّا الركيزة الثانية فهي الاستثمار في منظومة صحّية عمومية ناجعة، مع تنبيهنا أيضا إلى المصير المظلم الذي انجذب إليه هذا القطاع. ويمثّل الاستثمار في الثورة الرقمية ركيزة ثالثة في هذا المشروع، أمّا الرابعة فهي الاستثمار في الانتقال الطاقي وتطوير القطاع الصناعي والذي يعدّ اليوم معطّلا عن العمل
ذاك هو تصوّر الرجل وقد يكون استهوى رئاسة الجمهورية التي لولا يوسف الشاهد لما اهتدت إليه. وفي هذه المسألة يقف القارئ للوضع في حيرة، لأنّ ذلك الخيط الرفيع الذي يصل الشخصيات الثلاثة بعضها ببعض لا يزال خفيّا ومستورا
فجميع تصريحات الفخفاخ الأخيرة ومنذ سنة على وجه التقريب تؤكّد أنّ للرجل مآخذ على الشاهد، وتنحو إلى تقديم تقرير سلبي عن فترة رئاسته للحكومة: إذ اعتبر إضراب جانفي 2019 كارثيا على اقتصاد البلاد، وأن سياسة الدولة كانت خاطئة، وأنّ الحكومة هي من أوصلت البلاد إلى هذه الحال من تدهور الدينار؛ مؤكّدا أنّ الحالة الكارثية تعود مسؤوليتها إلى الأربع سنوات الأخيرة وأنّ الخمس سنوات لحكم الترويكا هي براء من ذلك
وعلى هذا الأساس نقول إنّ الرجل لم يدار أو ينافق، وأن اقتراحه من الشاهد لرئاسة الحكومة أمر يبعث على الاستغراب، ويدعو أسئلة كثيرة طرحها الشارع التونسي: من بينها أنّ الشاهد غدر بنبيل القروي في اقتراح الفخفاخ سعيا إلى تهميشه استجابة لطلب الرئيس الذي لا يستسيغ القروي وحزبه. ومن قائل بأنّ الشاهد قدّم هذا المقترح استنادا إلى طلب من قيس سعيد حتى يدفع بالبرلمان إلى رفضه فتعاد الانتخابات ويصعد أنصار الرئيس والشاهد فتتعبّد الطريق لتحوير الدستور وتطبيق برنامج الرئيس. ومن ذهب إلى هذه الفرضية استدلّ بأنّه من السذاجة السياسية أن يناقض سعيد نفسه، فهو يدين بشعار » الشعب يريد » وفي الوقت نفسه يعيّن شخصا لا يريده الشعب بل رفضه. وهذه فرضية لا نستطيع إقصاءها
الثابت أنّ الشاهد اختار شخصية يمكن وصفها » بمكسورة الجناح » عارية من السند، وليس لها من نصير سوى حزب تحيا تونس، وإن عبّرت بقية الأحزاب عن عدم تحفّظها من تعيينه فهي إمّا أن تكون أحزاب مهمومة بنتائج رفضه أو ترى فيه شخصية لا تتعارض مع توجهاتها الإيديولوجية، وعلى كلّ فسحب الثقة منه وارد في جميع الأحوال. كان الشاهد بفضل الصداقة التي تربطه بالرئيس، والتناغم الغريب الجامع بينهما هو المنتصر في هذه العملية، لأنّه ضمن لنفسه البقاء في المشهد الحكومي، بل قد يكون قدّم شروطا على الفخفاخ ستتبيّن في المستقبل القريب
ومع ذلك يشعر المرء بأنّ ثغرة ما في هذا المشهد الجديد، وأنّ يدا تمسك بخيوط هذه العلاقات، هي صورة بديلة للصورة التقليدية. صورة تقرّ بأنّ ما قام به الشاهد ليس سوى النزول درجة في سلّم الحكومة ليظلّ الآمر الناهي، كيف لا وقد ضمّ قرطاج إلى القصبة. ولعلّ هذه اليد هي التي دفعت بالفخفاخ إلى الاستقالة من حزبه تمهيدا لإعلان انتمائه إلى حزب الشاهد، والأيام كفيلة بكشف المتواري من الحقائق
الدكتورة نائلة السليني