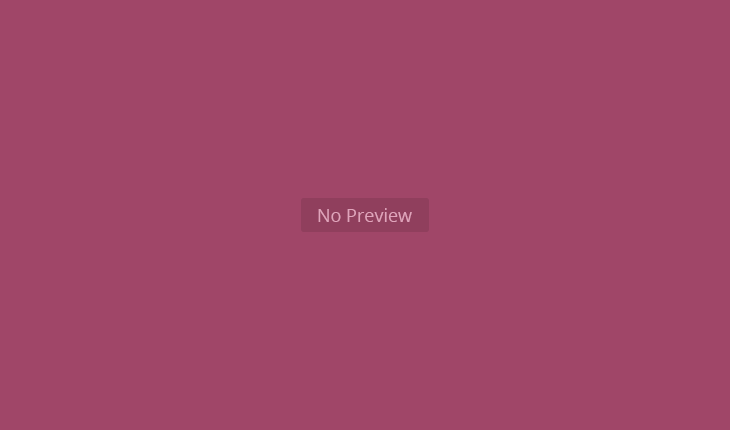صباح الخير: الكثيرات والكثيرون راسلوني طالبين منّي نسخة واضحة من مقالي الذي أردّ فيه على الزيتونيين.. أنقله إليكنّ(كم) اليوم 8 مارس.. عاش نضالنا ضدّ مقاربات الظلامية
عندما يحرّف « سدنة المعبد » الكلم عن مواضعه
1. في إشكالية المصطلح
نطق سدنة المعبد مرّتين تحت إمرة جامعتهم، مرّة في 17 أوت 2017 وأخرى في 01 فيفري 2018. نطقوا محذّرين من التوق إلى الحرية والمساواة. ولن تجد اختلافا فيما نطقوا به، بل كان الجماعة أوفياء لمنهجهم في علم النقل وساروا على درب المحدّثين في شرح المتون.. وعلى هذا الأساس يجوز أن ندرج الحديثين في نصّ واحد مركّب من متنٍ وشرحٍ. وإن انتظر مسلم أربعة قرون حتى يشرح النووي صحيحه فإنّ هؤلاء سارعوا وتكفّلوا بشرح متنهم بعد خمسة أشهر. وإن كان القارئ يقف على ثراء في نصّ النووي فإنّه يصدم في البيانين بجفاف العبارة وسطحيتها إن لم نقل كانا شهادة على تعطّل الفهم وعدول عن النصّ القرآني فكانا بمثابة الشهادة على قصورهم عن الدفاع على مقالات عاشت لقرون وهي اليوم عاجزة عن استيعاب هواجسنا نحن في القرن21م
ولأنّي حريصة على التأنّي في الردّ، ولأنّي أرغب في أن أحيط بجميع القضايا التي يثيرها البيان فقد رأيت أن أقسم ردّي إلى مقالين: أوّل في مسألة المصطلحات، وثان في مسألة تأثير الإيديولوجيا في جامعة الزيتونة وانعكاسها على تكوين طلبتنا
تعتبر المصطلحات الفقهية مسألة عويصة في بنية من حرّر البيان، وهي تجسيم لكيفية عدول الفكر التقليدي عن المنطلقات وهرولة نحو الارتماء في أحضان ما تبنّاه من مسلّمات اتقاء من لهيب إجهاد الفكر. فاجتمع في البيان مصطلحات اعتبرت ركيزة في الأدلّة الشرعية بالنسبة إليهم هي: المهر من منظور المخادنة والسفاح. وزواج التونسية بغير المسلم والمساواة، والإرث باعتباره من الأدلّة الشرعية. هي مسائل تقتضي منّا ردّا لأنّ السكوت على الضلالة ضلال قد يؤثّر في النفوس التي سرعان ما تهرع إلى راية ما اعتبر إيمانا.. وواجبنا يقتضي منّا بيان افتراء هؤلاء على النصوص
استند الجماعة إلى مجلّة الأحوال الشخصية مرّتين في المهر والإرث. وكدنا نصدّق أنّ الجماعة يتعبّدون بمجلّة الأحوال الشخصية بعد أن كانوا يرون فيها مصدرا للكفر، فإذا هم أكثر حداثة من الحداثيين، وإذا بالمجلّة تنسخ جميع أحكام الفقه التي تغذّي دماءهم. لم يدركوا أنّ المجلّة نسخت من أحكام المهر جميع المرجعيات الفقهية، فاعتبروا أنّ المهر » نحلة وهدية وليس بعوض عن منافع تقدّمها الزوجة لزوجها ». وهكذا محوا بالممحاة مرجعيتهم التي يتعبّدون بها، وأرى لزاما أن أذكّر هؤلاء الشيوخ والشيخات بالمرجعيات الفقهية التي بنتها الشريعة في أحكام المهر، عسى أن ينتبهوا إلى المسافة التأويلية التي يقطعها المؤوّل في التشريع للحكم، وحتى نقول لهم في الأخير: اختاروا نهجا واحدا، ولا ترقصوا على جميع الأنغام فقد تختلّ بكم وبنا القدم
أثبتت مدوّنات الفقه أنّ المناكح قائمة على البيوع، واكتملت في المهر شرائط البيوع من تسلّم وتسليم بعقد وشهود. وقديما قال مالك » أشبه شيء بالنكاح البيوع ». وتحدّث القرآن عن المهر بمعنى الأجر » فآتُوهنّ أجورَهُنّ فريضةً « (النساء4/24)، (المائدة5/5)، وتحدّث عنه بمعنى النّحلة في قوله » وآتُوا النّسَاءَ صدقَاتِهِنّ نِحلةً » (النّساء4/4). وعلى هذه الآيات نسج الفقهاء مفهوم الصّداق، فانطلقوا من رؤية جامعة تعتبره طريقا شرعيّا في استباحة الفروج بأن زكّاه الله في نعته بالنحلة، وعليه قامت علاقة الرّجل بالمرأة على أساس من التعبّد
وننبّه إلى أنّ المقدار في الصداق ليس بالزهيد كما قد يذهب بنا الظنّ: فقد أصدق عمر أمّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب أربعين ألف درهم، وتزوّج الحسن بن عليّ امرأة على مائة جارية ومع كلّ جارية ألف درهم… ومثل هذه الأخبار تؤكد أنّ أهمّ شرط في قدر الصّداق هو النّسب، والأمثلة موزّعة في مصنّفات الأخبار والفقه والتفسير. ولذلك كانت العلاقة بين الصّداق والوَلاية حميمة، وصار دفعُ الزوج أو الوليّ المهرَ وقبضه من الأب أو الأقعد في النسب رمزا لانتقال القِوامة من الأب أو الوليّ إلى الزوج، واعتبره المفسّرون ضربا من الاسترقاق حال الحرّة فيه مثل حال المملوكة، وهي رؤية استمدّت بقاءها من العرف الذي لا يقبل إلاّ ما يحفظ الانسجام بين طبقات المجتمع، وظلّت مرتسمة في كوامن المسائل المتّصلة بالصّداق والنّوازل المتفرّعة عنه، مثل دفع المهر العاجل والآجل، ويقتضي هذا قدرا من المهر مرتفعا يسهم في إنماء الاقتصاد الأسرويّ: كأن يمهر الرّجل المرأة حديقة أو مائة من الإبل
قد يذهب الجماعة في ردّهم على القضيّة إلى الاحتماء بخبر تزويج الرّسول إحدى الواهبات أنفسهن له لصحابيّ، واكتفائه بسورة من القرآن مهرا لها. وفي هذه القضيّة نسأل الجماعة عن موقفهم من افتقار هذه الزيجة إلى أهمّ شرطين في النكاح الصحيح، وهما الوَلاية والصّداق، (راجع ابن رشد) . ولن يقنعني التعلّل بأنّ الرسول وليّها، وخاصّة في تلك الفترة التاريخية من الوحي
فاللافت أنّ من حرّر البيانين يعاني قلقا وفزعا من كلّ جديد ومستنجدا بوجوب غلق باب الاجتهاد. لذلك تجده يرمي بالمصطلحات جزافا، خاصّة منها تلك التي تنفّر النفوس كالمخادنة والسفاح، والحال أنّ الآية التي يستندون إليها نزلت في مسألة الإماء أي المملوكات وليست في الحرائر، فقد أشار القرآن إلى السفاح والمخادنة في الآيتين 4/ 25، و 5/5 في سياق الحديث عمّن يَرُومُ إحصانا من الرجال ولا يطول الحرّة في دفع المهر » وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ (…) غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ … النساء4/ 25. ولم يعد لهذه الآية فعل تشريعي اليوم، فالمجتمعات الإسلامية تجاوزت مسألة العبودية ومنعتها، وتعاقب كلّ من طبقها بالسجن، شأنها في ذلك شأن آيات القطع أو الحرابة.. اللهمّ أن يكون من صدّر نفسه على كرسي الفتوى من الزيتونيات والزيتونيين يرجئون النظر في هذه المسائل إلى حين اكتمال دعوتهم التبشيرية الجديدة، وقيام دولة خلافة مثل دولة الدواعش
لم يكن حظّ لفظ المشركات بأحسن من غيره من الألفاظ، فقد التبس مفهوم المشرك بالكتابيّ في قوله » ولا تنكِحُوا المشْرِكاتِ حتّى يُؤْمِنَّ ولأمَةٌ مؤمِنَةٌ خيرٌ من مُشْرِكَةٍ ولوْ أعْجَبَتكُم ولا تُنْكحوا المُشْرِكين حتّى يؤْمِنوا … (البقرة2/221) . وكان معضلة الفقهاء والمفسّرين، ولا أقدر أن أجزم إن كانوا واعين بهذا المنهج الانتقائي الذي سلكوه.لأنّه يمثّل انحرافا من النظر في نكاح المشركة إلى البحث في نكاح الكتابيّة. وما من شكّ في أنّ أوائل المسلمين تعاملوا مع هذه الآيات باعتبارها وحدات دلاليّة مستقلّة، ولكن نما مفهوم الكتابيّ بحسب الظّروف السياسيّة/الاجتماعيّة التي مرّ بها المسلمون نتيجة الفتوحات التي أثّرت في مقالة الكفر والإيمان، فانقسموا في التشريع لمناكحتهم بين مجوّز ومحرّم، وكلاهما يستمدّ حجّته من تاريخ النّص ومن سلطة الخبر
كما ننبّه إلى أنّ القدامى لم يقفوا سوى عند الفاصلة التي تتحدّث عن نكاح المسلم كتابيةً، وأسقطوا بقية الآية. واتسم موقفهم بالصلابة وتحريم مناكحتها استنادا إلى عمر الذي أمر بفسخ نكاح طلحة بن عبيد الله وحذيفة بن اليمان من كتابيّتين، لا سيّما أنّه خالف ما حلّله النصّ، ولذلك يعرض علينا الطّبري مثلا شبكة من الرّوايات تتفق في المتن وتختلف في التعليل، ليستنتج » وإنّما كره عمر لطلحة وحذيفة رحمة الله عليهم نكاح اليهوديّة والنّصرانيّة، حذارا من أن يقتدى بهما النّاس في ذلك، فيزهدوا في المسلمات » . وسيكون لهذا الأمر حتما انعكاس في تركيبة المجتمع الإسلامي من جهة وفي نظام المواريث وخذلان المسلمات من جهة أخرى، فيختلّ التوازن بين الأحكام
لكن، لا يذهبنّ بكم الظنّ أنّني أدعو إلى منع الزواج ممن لا عقيدة له، فالمجتمع بلغ من التطوّر ما يجعلك تتحفّظ عن مثل هذه التأويلات: وبما أنّ الجماعة استندوا إلى دستور 2014 فلا بأس من تذكيرهم أيضا بالفصل 6 الذي ينصّ على حريّة المعتقد.. وفي الحقيقة نحن لا نأتي ببدعة في الفصل السادس، وإن كنّا المبادرين في الانفتاح على فلسفة القوانين الوضعية، فقد نقحت الجزائر دستورها سنة 2016 لتؤكد على عدم المساس بحرية المعتقد ُ وحرية الرأي … والتغييرات قادمة لا محالة في بلدان أخرى
أمّا حديثهم عن المواريث والمساواة فهما مشغلان يندرجان، في نظرهم طبعا، في سياق قطعية الدلالة، وهم في ذلك ينضوون إلى موقف الأزهر الذي نصّب بدوره نفسه كنيسة علينا. وأكتفي بجملة من الأسئلة لأنّني أفضت الحديث فيها في مقالات سابقة، ولو كانت لهم حجج لصدعوا بها في الإبّان، وما الاحتماء بقطعية الدلالة سوى برهان عن تهافت تعليلاتهم، وأوضّح
فإن كنتم تعتبرون ميراث الجدّ الذي فرضه عمر بعد وفاة حفيده من المقدّسات فكيف تقاربون مثل هذا الخبر عن عمر؟ » فقال عمر: إنّما الحاجة لي، إنّي جئتك لتنظر في أمر الجدّ. فقال زيد: لا والّله ما تقول فيه؟ فقال عمر: ليس هو بوحي حتّى نزيد فيه وننقص، إنّما هو شيء تراه، فإن رأيته وافقني تبعته، وإلاّ لم يكن عليك فيه شيء. فأبى زيد، فخرج مغضبا وقال: قد جئتك وأنا أظنّ ستفرغ من حاجتي. » وهل انتبهتم إلى أهميّة الوصيّة في القرآن؟ وهل ترون ميراث الولاء من التنزيل وقطعيّ الدلالة أم هو استجابة لوضع اجتماعي فرضته الغزوات؟
تبقى مسألة فهمهم للمساواة، وتلك قصّة من قصص ألف ليلة: فما أن نطالب بها حتى يمطروننا بسيل من المعاني الفقهية للاستدلال بأنّ ما ورد في الفقه ناطق بالمساواة، بل يذهبون إلى الاحتجاج بأنّ المساواة في المواريث خيانة لما أمر به الله في آيه، وأنّ المرأة ترث أكثر من الرجل في 30 حالة.. وغفلوا عن أنّ هذه الحالات لم ينطق بها نصّ، وزد إلى ذلك أنّ المجتمعات لم تعد تستجيب لهذه البنية الاجتماعية القديمة من تعدّد الزوجات إلى ملك اليمين
فللمساواة في نظرهم معنى فقهيّ هو غير المعنى الاصطلاحي المتداول في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فليس هو بلوغ الأفراد نفس الدرجة في القدر، وإنّما هو العدل في احترام مبدإ التراتبيّة بينهم، ومراعاة المفاضلة. وظلّ هذا المفهوم قانونا ثابتا يحتكمون إليه في شريعتهم: فالقدر في ديّة المرأة نصف قدر الرجل، قياسا على النصف في المواريث وتلك مساواة وعدل، تستوي مع الذمّي الذي يقاس قدره على نصف قدر الرجل المسلم. وقس على ذلك أحكامهم في القود التي كان لها انعكاس مباشر على انتظام الأفراد في المجتمع، وحفظت الفوارق بين الرّجل والمرأة احتماءا بمبدإ القوامة. فكان أن سقطوا في التناقض مثل قولهم في ديّة المرأة الّتي قطع أربعة من أصابعها أنّها تساوي الّتي قطع لها إصبعان. راجع ابن رشد
أدلّة الشرع يا سادتي في نصوصهم ليست سوى الشريعة التي ناضلنا وسكنّا الشوارع حتى منعنا إدراجها في الدستور، ولو كانت المواريث قطعية الدلالة لما احتاجوا إلى إنشاء » علم الفرائض » بديلا عن النصّ القرآني، ولو كانت قطعية في دلالتها لتحدّثوا عن الكلالة في القرآن، وتخلّصوا من الأدبيات الحافّة بالنصّ المقدّس حتى يقدّموا تفسيرا غريبا عنه وناشزا
حان الوقت للنفض غبار التقليد، غبار لا ينادي به سوى جاهل عاجز عن الفهم وقاصر عن التفكير
هذا الجزء الأوّل من الردّ، ومقالنا القادم في الإيديولوجيا التي تحرّك جامعة الزيتونة وخطرها على المجتمع والطلبة
نائلة السليني