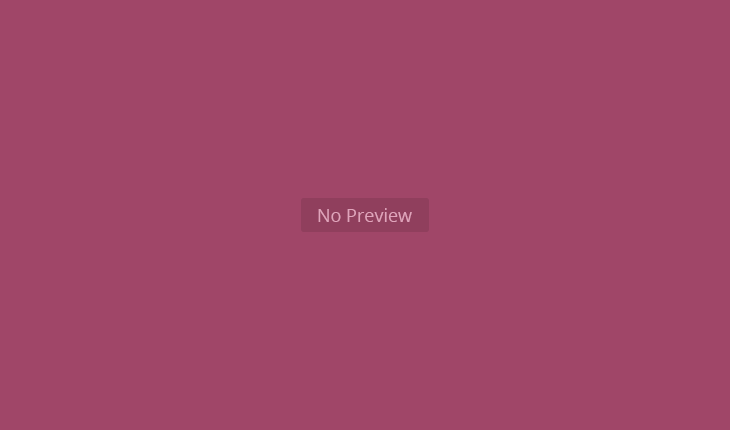كنت في السيّارة مستمعا إلى إذاعة المنستير تستقبل مواطنا أبدع في ماجل بلعباس فكرة ثلاّجة الكتاب. و في اللّحظة التّي استغربت فيها مثل هذا المشروع و قلت في نفسي إنّ الكتاب مثلّج و مجمّد بطبيعته و لعلّه يحتاج إلى سخّان لا إلى ثلاّجة، جاء إطناب المذيع في إطراء الفكرة و جاء تفسير صاحب المشروع لفكرته و لاصطلاحه عليه بثلاّجة الكتاب، ففهمت أنّ الرجل استهدى ثلاّجة قديمة معطّلة و وضع فيها كتبا له قديمة و عرضها للعموم يفتحون الثلاّجة و يقتنون منها ما يعجبهم يقرؤونه مجّانا و يرجعونه إلى الثلاّجة و ربّما أضافوا إلى الرصيد من كتبهم بما ينشئ دورة مجانيّة للقراءة و تداولا للكتب و إثراء لقوائمها. و فهمت أنّ هذا المواطن الصالح ابتدع، للإغراء بالقراءة، استعارة الثلاّجة استعارة مادّية و معنويّة وهي استعارة تمثيليّة تشبّه صورة الغذاء الروحي الذي يُتناول من الكتاب داخل المكتبة بالغذاء المادّي يُتناول من الثلاّجة و كانت الثلاّجة مضافةً إلى الكتاب هي القرينة الجامعة بين الصورتين و الموحية، باحتوائها للكتب، بتلك الصورة و الخالقة لعنصر الطرافة و الدّهشة في انفتاح باب الثلاّجة على رفوف الكتب. و من هذه الناحية نستطرف هذا الاصطلاح بثلاّجة الكتاب
لقد اعتمد صاحب هذه الاستعارة على الصورة الشعبيّة التّي تقتبس من الثلاّجة سمة من سماتها هي سمة جمع الطّعام و احتوائه و سمة الرمز إلى الخصاصة أو الكفاية في قولك : ثلاّجتي فارغة أو ثلاّجتي ملأى. غير أنّ سمة الاحتواء هذه ليست السمة الخاصّة بالثلاّجة إذ كلّ ما احتوى الطّعام يمكن أن يقوم مقامها و يكون مرادفا لها مثل القفّة مثلا أو المخزن أو البستان و غيره فكان يمكن لصاحب هذا المصطلح أن يتحدّث عن قفّة الكتاب أو بستان الكتاب مثلا.. و لكن من حقّ المتلقّي أن يستحضر في » ثلاّجة الكتاب » سمة ألصق بالثلاّجة و أقوى وهي سمة « المحافظة » فالثلاّجة تحفظ الطعام و تديم صلوحيته بتثليجه و تبريده و من أجل هذه السمة سُمّي هذا الجهاز على وزن الآلة من مادّة ث\ل\ج. و سمة التثليج سمة إيجابيّة إذا تعلّق الأمر بالمادّيات من طعام و مصبّرات غذائيّة و لكنّها تتحوّل إلى سمة سلبيّة إذا تعلّق الأمر بالمعنويّات و منها الاستعمال الشعبي في الترقيات الإداريّة : « فلان حطّوه في الفريقو » أو « المشروع الفلاني جمّدوه ».. و بهذا المعنى لا يصلح أن نتحدّث عن « ثلاّجة الكتب ». و من حقّ واضع هذا المصطلح أن ينوي التصوير الاستعاري الأوّل الحافظ للكتاب الذي هو الغذاء الروحي و لكنّه يستعير من الثلاّجة السمة الضعيفة و يذهب الناس في الاستعارة إلى وجه الشبه الأقوى لا سيّما إذا غابت القرينة الموجّهة إلى وجه الشبه. إنّ لنا في مثل هذا الخطاب الفنّي الشائع على الهواء و على الهوى المناسبة اللّعبيّة المتاحة لمراجعة نواميس اللغة و ملامسة حدودها و آفاقها
الدكتور الهادي جطلاوي